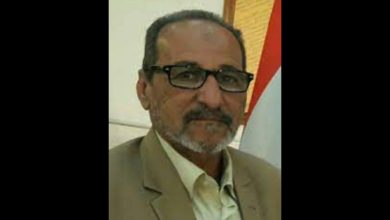مدبولي يوجه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير لإفريقيا

القاهرة في 3 أكتوبر / أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، حيث يتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجهًا بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تُنسق مع المصدرين الزراعيين؛ بهدف تذليل العقبات التي تواجههم، وتيسير الإجراءات؛ لزيادة صادراتهم الزراعية بوجه عام، وخاصة إلى الدول الإفريقية، شارحًا ما يتم من خطوات في هذا الشأن.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “مستعدون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعادة هيكلة دعم الصادرات، مع زيادة المخصصات الموجهة للصادرات الخاصة بإفريقيا، ومستعدون أيضًا للتنسيق بشأن تذليل أية عقبات في هذا الملف”.
وأضاف وزير المالية: تعمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وعدد من الدول الافريقية على تفعيل منصة التبادل التجاري الافريقية (ATEX) والتي سوف تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وخاصة في السلع الزراعية.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم التنسيق بشأن زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك ضمان للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.
وقام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باستعراض ما تقوم به شركة الجسر العربي، وغيرها من الشركات الأخرى، من جهود لنقل البضائع والمنتجات المصرية إلى الدول المختلفة، والإجراءات المتخذة؛ لزيادة الشاحنات، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود تعاقدات تصديرية إلى أفريقيا، أو غيرها، فوسيلة النقل ستكون جاهزة.
كما أشار وزير النقل، إلى أن النقل البري قريبا سيفتح الطريق للوصول لمنتجاتنا إلى أفريقيا، عبر محور القاهرة كيب تاون.
وقالت نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية: “لدينا حاليًا فرصة ذهبية لزيادة صادراتنا إلى شرق إفريقيا، خاصة الصادرات الزراعية، وقامت بشرح رؤيتها لدفع الصادرات الزراعية إلى القارة الإفريقية”.
وخلال الاجتماع، تطرق السفير شريف عيسي، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى ضرورة تحديد الدول المٌستهدفة في البداية، وكذا إمكاناتنا للتصدير من المنتجات المختلفة، وكذلك العمل على حل المشكلات التي تواجهنا عند التصدير، خاصة لإفريقيا، والعمل على توحيد الجهات الخاصة بالتصدير حتى لا تتعدد المسئوليات.
وأضاف عيسى: “لدينا منطقة لوجستية فاعلة حاليًا في تنزانيا، بالتنسيق مع رجال الأعمال، ونعمل على إنشاء منطقة في دولة أخرى، ووزارة الخارجية مستعدة لتقديم كل سبل الدعم المطلوب”.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزي والجهات المعنية؛ لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية؛ لزيادة صادراتنا، خاصة إلى الاشقاء في إفريقيا، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.
ج.م