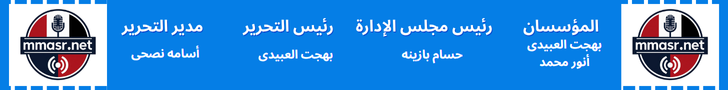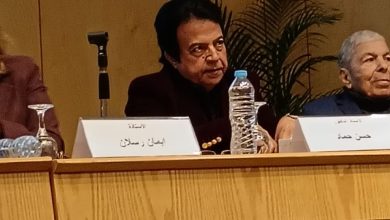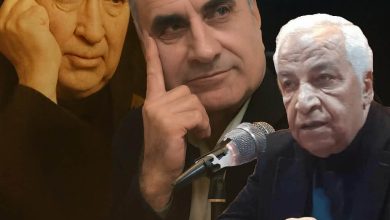القصة بوصفها فنا من فنون الصناعات الإبداعية في العالم العربي .. المغرب ولبنان ومصر أنموذجا

مشغل الصوت
بقلم هدى نصر الدين البكاى رئيسة المجلس الاستشاري بشبكة إعلام المرأة العربية
المقدمة
تتطلب مقاربة موضوع: “القصة بوصفها فنا من فنون الصناعات الإبداعية في العالم العربي” المغرب ولبنان ومصر أنموذجا” تحديد إطار مفاهيمي واضح، يبدأ بفهم الصناعات الثقافية بوصفها حقلاً يدمج الإبداع الفني والبعد الاقتصادي في آن واحد؛ إذ عرّفها الباحث البريطاني ديفيد هيسموندالغ (David Hesmondhalgh)، أحد أبرز منظّري الصناعات الإبداعية، بأنها «القطاعات التي تنتج رموزًا ومعاني يُعاد توظيفها باستمرار لتحقيق قيمة ثقافية واقتصادية”.
أما في السياق العربي، فتذهب الباحثة المغربية زهور كرام إلى تأكيد هذا الارتباط بين السرد بحسبانه جنسًا أدبيّا والصناعة الرمزية، إذ تقول في كتابها “السرد في التداول الثقافي” ما نصّه:
” السرد العربي لم يعد فعل كتابة فرديًّا فقط، بل صار صناعةً ثقافية تتطلب تخطيطًا وإنتاجًا وتسويقًا، لتصل إلى المتلقي وتخلق دائرة جديدة من التداول”.
إن هذا التحوّل من الكتابة الفردية إلى الإنتاج الصناعي، يجعل القصة القصيرة اليوم جزءًا من شبكة معقدة تشمل: دور النشر، الجوائز الأدبية، الملتقيات، منصات القراءة الرقمية، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي التي غيّرت من أنماط القراءة والتوزيع معًا.
من هنا، تنطلق هذه الورقة لوصف الظاهرة وتأمل أبعادها، مع مقاربة نقدية ثقافية لتفكيك الخطابات التي أحاطت بتحوّل القصة إلى سلعة رمزية، ثم إطار مقارن لتتبع أوجه الشبه والاختلاف بين تجارب ثلاثة أقطار عربية هي المغرب ولبنان ومصر.
ولتحقيق ذلك، تعتمد الورقة أمثلة حيّة من كتاب معاصرين مثل محمد سعيد الريحاني (المغرب) الذي دافع عن القصة القصيرة جدًا بحسبانها جنسًا جديدًا ينسجم مع إيقاع العصر، وهدى بركات (لبنان) التي ترى أن السرد ليس مجرّد حكي بل «تأريخ ذاتي لحياة عامة» يمكن أن يُستثمر ثقافيًا، ويحيى حقي (مصر) الذي مثّل حلقة مبكرة في تحويل القص إلى مدرسة تُعيد إنتاج قارئها وتؤثر في ذائقة المجتمع.
أولا: القصة والصناعات الإبداعية: قراءة نقدية عامة
إنّ الحديث عن القصة القصيرة بحسبانها جزءًا من الصناعات الثقافية في العالم العربي يكشف منذ البداية عن مفارقة أساسية: فهي فنّ يقوم في جوهره على الاختصار والاختزال، على التلميح لا الإطناب، بينما يفرض منطق السوق الإبداعي ضرورة وجود آليات منظّمة للإنتاج والترويج، فإن هذه الآليات تضع على النص عبئًا تجاريًا قد يكون ثقيلاً عليه إذا ما قُيّم فقط وفقًا لمعايير جمالية بحتة. ولذلك، يرى بعض الباحثين أن إخضاع القصة القصيرة لمنطق «الصناعة الثقافية» قد يؤدي إلى فقدان جزء من حريتها وفرادتها التجريبية؛ لأن الضغوط السوقية تتطلب غالبًا التكرار والسهولة في الاستهلاك على حساب الابتكار والعمق الفني.
يُذكّرنا هذا بقول الناقد المصري صلاح فضل في كتابه «أساليب السرد في الرواية العربية» حين تحدّث عن القصة القصيرة قائلاً: “إن القصة فنٌّ حساس، كلّما اقترب من التعميم الإنتاجي فَقَدَ شيئًا من خصوصيته”
وإن كان فضل هنا يتحدث عن القصة والرواية معًا، فإن دلالته النقدية دقيقة: القصة فنّ هشّ إذا ما جُرّ إلى آليات السوق الجاهزة من دون أن يُراعى بُعده الجمالي.
مع ذلك، لا يمكن إنكار أنّ السنوات الأخيرة شهدت تحولات جادة في إدماج القصة ضمن منظومات إنتاج الثقافة وتداولها. فقد ساعدت جوائز مثل «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» (الكويت) على إعادة الاعتبار لهذا الفن، عبر تخصيص مكافآت مالية كبيرة ودعم طبعات خاصة للفائزين. كما ظهرت مبادرات شبابية رقمية مثل منصّة «أوكسجين» ومجموعات النشر الذاتي العربية، التي تتيح للكتّاب الجدد نشر قصصهم إلكترونيًا ثم تجميعها لاحقًا في كتب توزع ورقيًا، ما خلق ديناميّة جديدة بين الكاتب والقارئ والناشر.
وفي المغرب، مثّل مشروع «ورشة أطياف» أنموذجًا ملموسًا لورشة إبداعية جماعية تُنتج مجموعات قصصية لشباب كُتّاب، وتطبعها بنسخ محدودة، ما يجمع بين التجربة الأدبية وروح التصنيع الرمزي للنصوص. وفي لبنان، كانت مبادرات مثل «نادي القصة» في بيروت و«ملتقى بيروت للقصة القصيرة».. تدلّ هذه المؤشرات على أن القصة القصيرة لا تزال قادرة على الوصول إلى قرّاء فعليين ومهتمين، رغم الضغوط والتحديات التي يفرضها سوق النشر والثقافة.
لكن يبقى التحدّي الأكبر أنّ هذه الجهود – وإن بدت صناعية في ظاهرها – لا تتكامل غالبًا مع البنى الاقتصادية الكبرى: إذ يظلّ توزيع الكتاب العربي محدودًا، وضعيفًا أمام المنافسة الرقمية الواسعة، كما أنّ دور النشر كثيرًا ما تتعامل مع القصة القصيرة بحذر مالي لصالح الرواية التي تضمن ربحًا أكبر عبر الترجمات والتسويق.
إن هذه المفارقة تدفعنا لطرح السؤال النقدي الآتي: هل يمكن للمؤسسات الثقافية العربية أن تؤسس حقًا لصناعة قصصية تواكب متطلبات السوق من جهة، وتحافظ على الرصيد الجمالي لهذا الفن من جهة ثانية؟
ثانيا: القصة القصيرة في المغرب: جدلية التجديد وصناعة التداول
تمكّنت القصة القصيرة في المغرب من التجدد والانطلاق، وإيجاد مكان لها في ميدان الصناعات الثقافية العربية، رغم الصعوبات التي تواجهها مثل قلة الموارد وصعوبة التوزيع. فقد كانت القصة المغربية تُنتج لحقبة طويلة ضمن نطاق محدود ومغلَق، لكن منذ التسعينيات بدأت تأخذ طابعًا جماعيًا وشبه صناعي، بفضل دعم الجوائز الوطنية، والدوريات الأدبية، وورش الكتابة، ومبادرات الترجمة التي فتحت آفاقًا جديدة أمامها وأعطتها فرصًا أوسع للتداول والانتشار.
في هذا السياق، أدت أسماء بارزة مثل محمد سعيد الريحاني دورًا محوريًا؛ إذ عُرف الريحاني باهتمامه الإبداعي في «القصة القصيرة جدًا»، التي يعدّها امتدادًا طبيعيًا لإيقاع العصر الرقمي، ويؤكّد في أحد مقالاته: “القصة القصيرة جدًا ليست ترفًا بل استجابة جمالية لمطلب السرعة وتعدد الوسائط”. (الريحاني، مقالة منشورة على «أوكسجين» 2015).
بهذا الطرح، يوضح الريحاني كيف أن شكل القصة القصيرة جدًا يتناسب مع متطلبات القارئ الحديث، الذي يتنقل بين قراءة النصوص الورقية والرقمية على الشاشات، مما يجعل هذا الشكل الأدبي ملائمًا لعصر الوسائط المتعددة وسرعة الاستهلاك.. وقد أصدر الريحاني عدّة مجموعات ضمن هذه الرؤية مثل “خلف الستار” و”عناكب التراب”.في المقابل، اهتمّت الناقدة زهور كرام بقراءة تحوّلات السرد المغربي في إطار الصناعات الثقافية، مؤكدةً أن «المسألة لم تعد تقتصر على الإبداع الفردي بل على مأسسة الفعل السردي»، وقد بيّنت ذلك في أكثر من دراسة، من بينها كتابها «السرد في التداول الثقافي» (2011) الذي صار مرجعًا أساسيًا لدراسة العلاقة بين النص والفضاء التداولي في المغرب.
على مستوى البنية المادية، تبرز مبادرات مثل «ورشة أطياف» التي انطلقت بوصفها تجمعا شبابيا إبداعيا في الدار البيضاء وأسهمت في تقديم عشرات الكتّاب الشباب، عبر طبع مجموعاتهم القصصية في طبعات محلية، وفتح مجال القراءات الحيّة. إن هذه الورش تمثّل خطوة باتجاه تحويل القصة إلى منتَج إبداعي يُتداول خارج الحلقة المغلقة للنخب الثقافية.
رغم التطورات الإيجابية، يحذر النقد المغربي من مخاطر تسليع النص الأدبي؛ إذ تحولت بعض المشاريع القصصية إلى أعمال شكلية تهدف فقط إلى الفوز بالجوائز أو الحصول على دعم مؤقت، دون بناء قاعدة قراء حقيقية. والتحدي الأساسي هنا هو: كيف يحافظ الكاتب المغربي على جمالية القصة وتميزها، في ظل الضغوط المالية والتسويقية.
كما أن مؤسسات مثل اتحاد كتاب المغرب لم تقدم دائمًا دعمًا كافيًا لصناعة قصصية متكاملة، فظل الرهان الأكبر على المبادرات الفردية والشبابية التي تواجه صعوبات في النشر والتوزيع. ومع ذلك، يبقى المغرب من أكثر الدول العربية خصوبة في إعادة تموضع القصة القصيرة ضمن الصناعات الثقافية، بفضل جهود الكتّاب والناشرين والنقاد.
ثالثًا: القصة القصيرة في لبنان: النص السردي بين الذاكرة وسوق الثقافة
يُعدّ لبنان من الدول العربية الأكثر ثراءً على مستوى تنوّع التجربة السردية، إذ ظلّت القصة القصيرة فيه مجالًا للتجريب والتعبير عن رفض الواقع، بخاصة مع تعاقب الظروف الصعبة التي صنعت من بيروت فضاءً منفتحا لاستقطاب الأقلام الفردية والجماعية على السواء. غير أنّ خصوصية القصة اللبنانية لا تقتصر على موضوعاتها أو لغتها، بل تمتدّ إلى علاقتها بسوق الثقافة وكيفية تدويرها ضمن منظومة الصناعات الإبداعية. منذ خمسينيات القرن الماضي، أسهم كتّاب مثل يوسف حبشي الأشقر وتوفيق يوسف عواد في ترسيخ فن القصة بحسبانه جنسًا أدبيًا لبنانيًا أصيلًا يتقاطع فيه الهمّ الاجتماعي بالبعد الجمالي. وفي أزمنة لاحقة، ظهرت أسماء جديدة أعادت تموضع القصة ضمن فضاء هموم الواقع الاجتماعي والسياسي، نذكر منهم هدى بركات، التي وإن عُرفت أكثر برواياتها، كتبت قصصًا حملت ملمحًا تجريبيًا ينفتح على مفهوم «الذاكرة الحيّة». تقول بركات في أحد حواراتها: “الكتابة ليست توثيقًا لماضٍ ثابت بل إعادة خلق مستمر للذاكرة كي تظلّ حية في حاضر مضطرب».
هذا الرؤية جعلت من القصة القصيرة في لبنان أداة لإنتاج سردٍ رمزي، يمكن أن يُستهلك ثقافيًا كوثيقة أدبية لها حضور في السوق الثقافي العربي.
من الناحية العملية، لم تخلُ التجربة اللبنانية من أدوات صناعية ساعدت على تداول النص القصصي: فقد نشطت دور نشر متخصصة مثل دار الساقي التي تبنّت أعمالًا قصصية لمؤلفين شباب، إلى جانب مبادرات مثل «ملتقى بيروت للقصة القصيرة» الذي جمع كتّابًا عربًا وأتاح لهم فضاءً للنشر والترويج. كما أسهمت الجوائز الأدبية المحلية، ومنها «جائزة سيمون الحايك»، في تحفيز بعض الكتّاب على العودة إلى القصة بعدما هيمنت الرواية طويلًا.
كذلك، أدت الصحافة الثقافية اللبنانية دورًا مهمًا في تشكيل سوق مصغّر للقصة القصيرة.. ومع تحوّل المشهد الإعلامي إلى الرقمنة، ظهرت مواقع ومنصات رقمية مثل «الآداب الإلكترونية» التي استضافت نصوصًا قصصية جديدة وأتاحت لها فضاءً تفاعليًا مع القارئ.
ورغم هذه الأدوات والفرص، ظلّت القصة اللبنانية تواجه التحدي نفسه الذي يواجهه مثيلها في بقية العالم العربي: تهميش النشر القصصي لصالح الرواية ذات السوق الأكثر استقرارًا وعوائد أوضح. من هنا يُطرح السؤال النقدي: هل يكفي أن تبقى القصة اللبنانية محصورة بين دور نشر محدودة وصحف ثقافية تتضاءل مساحتها، أم أن التحوّل الرقمي يتيح اليوم فرصة لتأسيس صناعة قصصية أكثر انفتاحًا وتوزيعًا؟
رابعا: القصة القصيرة في مصر: الريادة والإنتاج الثقافي
تُعدّ مصر بلا منازع «مهد» القصة القصيرة العربية الحديثة، حيث بدأت بوادر هذا الفن تتبلور منذ أوائل القرن العشرين، مع رواد مثل محمد تيمور وطه حسين، ثم اتسعت رقعته وتطوّرت على يد أجيال متعاقبة مثل يوسف إدريس وبهاء طاهر، الذهذا الجيل الذي أسهم في بلورة القصة بحسبانها جنسًا أدبيًا مستقلًا له قواعده وتقنياته.
هذا التاريخ العريق منح مصر موقعًا خاصًا في منظومة الصناعات الثقافية العربية، إذ لم تقتصر القصة على كونها ممارسة أدبية فحسب، بل تحولت تدريجيًا إلى صناعة ثقافية متكاملة، تشمل دور النشر، الجوائز، الورش الإبداعية، وحتى منصات القراءة الرقمية.
من الناحية المؤسسية، أدت دور النشر مثل دار الهلال والمركز القومي للترجمة دورًا محوريًا في دعم القصة القصيرة من خلال نشر مجموعات قصصية وترجمتها إلى لغات أخرى، ما أسهم في تصدير المنتج الثقافي المصري. كما أسهمت جائزة ساويرس الثقافية في تحفيز الكتّاب الشباب على الإبداع في القصة القصيرة، مع منحها مكافآت مالية وفرص نشر واسعة.
على صعيد الممارسة الرقمية، استفاد الكتّاب المصريون من التحول الرقمي بشكل عام عبر المدونات الأدبية الشخصية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات العربية الأوسع مثل «أبجد» أو «الكتب المفتوحة» التي أتاحت نشر القصص إلكترونيًا وتوسيع قاعدة القرّاء خارج النشر الورقي التقليدي. كما ساعدت صفحات الأدب في الصحافة الرقمية على إبقاء القصة القصيرة حاضرة ومتداولة في الفضاء الثقافي الجديد.
مع ذلك، تُواجه القصة القصيرة في مصر تحديات شبيهة بتلك التي تعاني منها باقي البلدان العربية، خاصة من حيث محدودية سوق الكتاب الورقي وتشتت الجمهور، ما يفرض على الكتّاب والمبدعين البحث عن آليات إنتاج وترويج مبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية للصناعة الثقافية.
تطرح هذه التجربة المصرية سؤالًا نقديًا مركزيًا حول مدى نجاح الرواية والقصص القصيرة في استثمار هذه المنصات الجديدة لتحقيق توازن بين الإبداع الفني ومتطلبات السوق الثقافي المعاصر.
الخاتمة: نتائج وتوصيات ورؤية مستقبلية
تؤكد هذه المداخلة أن القصة القصيرة في العالم العربي تعيش حالة تقاطع معقدة بين الإبداع الفني ومنطق السوق الثقافي، حيث باتت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الصناعات الإبداعية، رغم هشاشتها وتفاوت دعمها عبر البلدان. أظهرت التجارب المغربية، واللبنانية، والمصرية كيف استطاعت القصة أن تجد لنفسها مساحات إنتاج وتداول جديدة عبر الجوائز، ودور النشر، والمنصات الرقمية، إلى جانب الورش والمبادرات الثقافية، مما يعكس تحوّلًا حقيقيًا من الفعل الفردي إلى صناعة ثقافية جماعية.
ومع ذلك، فإن هذه الصناعة ما تزال تواجه تحديات بنيوية عميقة تتمثل في محدودية البنى التحتية للنشر، وتذبذب جمهور القراءة، وصعوبة الحفاظ على التوازن بين القيمة الجمالية والقيمة الاقتصادية للنص القصصي. ويظل السؤال النقدي المحوري قائمًا حول إمكانية تطوير بنى تحتية مؤسسية أكثر تكاملًا تضمن بقاء القصة القصيرة فنًا ذا جودة عالية ومنتجًا ثقافيًا مستدامًا في آن معًا.
في المستقبل، يبدو أن الاستثمار في الرقمنة، والقراءة التفاعلية، وربط الإنتاج الأدبي بسوق الثقافة الرقمية، يمكن أن يشكل مخرجًا واعدًا لمواجهة هذه التحديات، شرط أن يُصاحب ذلك اهتمام نقدي وعلمي مستمر يعيد قراءة العلاقة بين الفن والصناعة، ويؤكد على ضرورة حماية الإبداع من التبعية المطلقة لمنطق السوق.
هذه المداخلة تدعو إلى المزيد من البحث والنقاش حول صناعة القصة القصيرة في الوطن العربي، كفنٍ يعبّر عن هويات متجددة وثقافات حية، وفي الوقت نفسه كمنتج ثقافي يُنتج قيمة اقتصادية وفكرية في عالم سريع التغير.