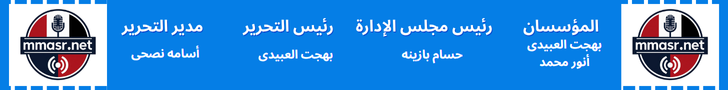فتوى مصطفى العدوي.. حين يخاف الكهنوت من وعي المصريين

مشغل الصوت
بقلم/ هشام النجار
وقف المصريون أمام المتحف المصري الكبير كما لو أنهم يفتحون نافذةً على مجدهم القديم، نافذة تُطلّ منها الروح المصرية على ذاتها بعد قرون من التشويه والاغتراب.
وفيما كان العالم كله يشهد احتفاليةً فريدة وحضارةً تنهض من جديد في مشهد يوحّد المصريين على حب بلادهم وتاريخهم، خرجت فتوى عجيبة من ظلام الماضي على لسان أحد رموز ما يُعرف بالدعوة السلفية، مصطفى العدوي، تُحذّر النَّاس من زيارة المتحف بحجة “الخوف على العقيدة من حبّ فرعون”!
هذه الفتوى لم تكن حدثًا عابرًا، بل مرآة لأزمةٍ فكريةٍ ممتدة، تُعيد إنتاج الكهنوت الديني نفسه الذي قاوم كل نهضةٍ عقليةٍ منذ قرون؛ فهؤلاء الفقهاء التراثيون لا يرون في الإيمان قوةً تملأ القلب نورًا، بل يرونه هشًّا إلى حدّ يمكن أن يسقط أمام تمثال أو بردية، مع أن جوهر الإيمان في القرآن قائم على التفكر والتدبر في خلق الله وفي مصائر الأمم السابقة:
.(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل)
الآية تأمر بالسير والنظر والتأمل، لا بالانكماش والخوف والتحريم.
المفارقة أن الحضارة المصرية لم تكن يومًا خصمًا للتوحيد، بل كانت من أوائل الحضارات التي بشّرت بفكرة الخالق الواحد، وبالجزاء بعد الموت، وهي ذاتها القيم الواضحة بالرسالات السماوية وبلغت ذروتها في الرسالة الخاتمة التي بُعث بها الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.
كما أن المتحف ليس معبدًا ولا صنمًا، بل مدرسةٌ للتأمل في سنن الله في الكون والتاريخ، وفي أن الأمم تزدهر حين تبني وتزول حين تفسد وتستبد، إن من يخاف من التاريخ، إنما يخاف من الوعي، ومن يدّعي حماية العقيدة من التمثال، إنما يحمي سلطته على العقول.
لقد تحررت مصر بعد 2013 من جماعاتٍ ضالةٍ كانت تريد تحويل الدين إلى سجنٍ روحي وعقلي، تُحاكم الجمال وتُكفّر الفرح وتُحاصر الضوء باسم “الغيرة على التوحيد”.
لكن جوهر المعركة لم يكن سياسيًا فقط، بل فكريًا أيضًا؛ معركة استرداد الدين من أيدي من شوّهوه، وإعادته إلى مجراه “الإلهي الخالص”، دين الرحمة والوعي والبناء لا الإكراه والكراهية.
وأبطال هذه المرحلة المنقِذون لم يدافعوا عن الوطن فحسب، بل عن صورة الإسلام ذاته، ليظل على صفائه الأصلي، مصدر محبةٍ وسلامٍ بين الناس، ومُلهمًا للشعوب أن تجد سكينتها في الإيمان لا في الخوف.
إن ما فعله مصطفى العدوي ليس إلا صدىً جديدًا لأصواتٍ قديمة كانت ترى في كل حجرٍ وثنًا، وفي كل فكرةٍ تهديدًا، وفي كل انفتاحٍ فتنة؛ هؤلاء امتدادٌ لمن شوّهوا الرسالات السابقة وغلّفوا الباطل بثياب القداسة، فصنعوا كهنوتًا جديدًا باسم “السُّنة والمرويات”، بينما القرآن يعلّمنا أن الانحراف يبدأ حين يُقدَّم كلام البشر على كلام الله، وتُجعل الروايات شريكةً للوحي.
والمفارقة التاريخية أن الذين حرّموا النظر إلى التماثيل هم أنفسهم الذين صنعوا في عقول الناس “أصنامًا فكرية” تُعبد من دون الله، أصنام الرجال والمرويات والمذاهب؛ تلك هي الوثنية الحقيقية الجديدة التي تحاصر العقول وتمنعها من أن تبصر نور الله عز وجل في كتابه المجيد.
لقد رأى العالم كيف هدم تنظيم داعش متاحف وآثار العراق وسوريا وليبيا، وكيف دمّرت طالبان تراث أفغانستان، تحت الذريعة ذاتها: “هذه تماثيل محرّمة”.
تلك الممارسات لم تكن بعيدة عن إستراتيجيةٍ غربيةٍ قديمة تسعى إلى إبقاء صورة الإسلام مقترنةٍ بالجهل والدمار، ليتعزّز التفوق الحضاري الغربي وتُعاق كل محاولةٍ لنهضة عربية حقيقية.
الغرب لم يحتج بعد ذلك إلى جيوشه، فقد أوجد فينا من يفعل مهمته بأيدينا، يهدم أوطاننا باسم الدين، ويغتال وعينا باسم الغيرة على الإيمان.
والسؤال الذي يفرض نفسه:
ماذا لو استمر حكم الإخوان والسلفيين (المتأخونين والمتسلفين)؟
كيف كانت ستكون ملامح مصر اليوم؟
كفي أن نتذكر أن بعض منظّريهم دعا ذات يوم إلى “تغطية التماثيل بالشمع” ووصف الحضارة الفرعونية ب”العفنة”، وآخر أعلن على شاشة التلفاز أن “التماثيل الحجرية حرام” وأن “تطبيق الشريعة يقتضي هدم الأهرامات وأبو الهول”!
لم يكن ينقص هؤلاء سوى سلاح داعش وقبضته على السلطة ليكتمل المشهد.
لكن مصر -التي علّمت العالم معنى البقاء- رفضت أن تُحْكَم باسم الموت، واختارت الحياة.
اليوم، حين يُفتح المتحف الكبير، لا تُفتَح فقط قاعات للعرض، بل تُفتح صفحات الوعي في ذاكرة الأمة.
إنه إعلانٌ أن المصريين لا يعبدون حجارة، بل يحتفون بالعقل الذي نحتها ببراعة لا تزال تُذهل العالم، وبالروح التي بحثت من خلالها عن الله والخلود والسُّمُو والعدل.
الحضارة ليست ضد الدين، بل هي ثمرة الإيمان الحق، لأن الوحي لا يعادي العلم ولا الفن ولا الجمال، بل يجعلها طريقًا لمعرفة الخالق.
الفتنة الحقيقية إذن ليست في “حب الفراعنة”، بل في حب الكهنوت الذي يكره النور، الذي يمثله العدوي وكل من لفّ لفه وانتهج نهجه.
أما الإيمان الحق، فهو أن نحب الله كما نخافه، وأن نقرأ تاريحنا بعين القرآن الكريم (كتاب الله المقدس)، لا بعين الرُّعب الذي يملأ صفحات الروايات والإسرائيليات والأساطير والخرافات التي كرسها مصطفى العدوي وأشباهُه.
فالله لم يأمرنا أن نهدم تماثيل التاريخ، بل أن نهدم الأصنام التي نُصبت في العقول، تلك التي تحول بين الإنسان وبين النور المبين.