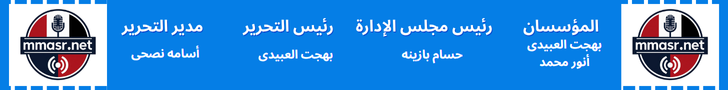رصيف الانتظار … قصة قصيرة

مشغل الصوت
بقلم: الكاتبة ھدى حجاجي احمد
كانت تأتي كل يوم عند السابعة صباحًا، قبل أن تفتح المحال أبوابها، وقبل أن تبدأ العصافير ترتّب أصواتها على أسلاك الكهرباء.
جلست في ذات الزاوية، على المقعد الخشبي في نهاية الرصيف، تحمل فنجان قهوتها، ودفترًا صغيرًا بلون العاج.
لم يكن المكان مزدحمًا، فقط رجال يمرّون إلى أعمالهم بسرعة، نساء يجررن أطفالًا نائمين إلى المدارس، وموظف المحطة الذي حفظ ملامحها دون أن يسأل شيئًا.
كانت تكتب كثيرًا، وتمحو أكثر.
تفتح دفترها وكأنها تفتح نافذة صغيرة في قلبها.
كلّ يوم، صفحة جديدة.
“إلى متى ستظلين هنا؟”
سألها عامل المقهى وهو يضع كوب القهوة على الطاولة.
ابتسمت، وقالت دون أن ترفع عينيها عن القطار المارّ:
— “حتى تُغيّر الرياح اتجاهها.”
ضحك الشاب، لكنه لم يفهم.
في جيب معطفها، كانت تحتفظ بتذكرة قديمة، طُبعت منذ عامين.
رحلة إلى مدينة لم تصلها قط.
هي لم تكن تنتظر القطار، بل تنتظر المسافر الذي لم يأتِ،
ذلك الذي قال لها ذات مساء:
> “إن تأخرت، انتظريني هناك… على الرصيف الأخير.”
ومنذ ذلك اليوم، لم يكتب، لم يتصل، لم يعتذر.
لكنه ظلّ يسكن نصوصها،
يتسلّل إلى أحلامها،
ويعود في الذاكرة كنسمة لم تجرحها الريح، لكنها أخذت معها كل عبير.
في أحد الأيام، تأخرت عن المجيء.
لم يلحظ غيابها إلا عامل المقهى.
ظلّ يحدّق بالمقعد الخشبي، ثم نظر إلى ساعته.
في اليوم التالي، جاءت.
لكنها لم تجلس.
اكتفت بالوقوف.
نظرت إلى القطار القادم، ثم إلى السماء،
وقالت همسًا:
— “أنا من تأخّرت هذه المرة… ليس هو.”
سحبت الدفتر من جيبها، وفتحت على الصفحة الأخيرة.
كتبت:
> “أحيانًا لا ننتظر أشخاصًا… بل ننتظر أنفسنا،
تلك النسخة التي كنا نكونها ونحن نحبّهم.
وقد لا تعود.”
تركت الدفتر على المقعد،
وغادرت قبل أن تصل أول عربة.
لم تعد إلى الرصيف بعدها.
لكن أحدهم – ذات مساء – وجد الدفتر،
قرأ الصفحة الأولى:
> “إلى من غاب، وظلّ في النور…
إن عدتَ، فأنا زهرة على الضفّة،
تؤمّ ظلّك، وتصلي بالعصافير أن تراك.”
وأغلقه…
ثم جلس على المقعد،
ينتظر
هل كانت هي الراحلة؟
أم هو العائد متأخرًا؟
لا أحد يعرف.
لكنّ الريح…
غيّرت اتجاهها في ذلك اليوم.