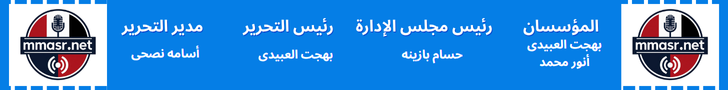عاشوراء بين السنة والشيعة: اتفاق في التقديس واختلاف في المعنى والطقوس
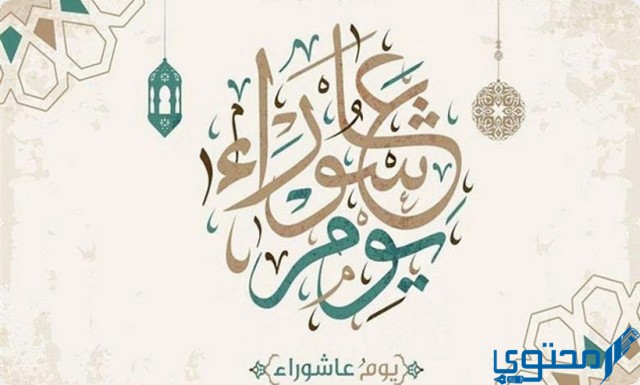
مشغل الصوت
بقلم: المؤرخ العصري
يُعد يوم عاشوراء، العاشر من شهر محرّم، من أبرز الأيام التي تركت بصمتها في الذاكرة الإسلامية، حيث يتجلى فيه التداخل بين التاريخ والدين والسياسة، وتتباين فيه المواقف بين السنة والشيعة، بما يعكس تنوع الرؤية وتعدد الأبعاد داخل البيت الإسلامي الواحد.
جذور القداسة: من موسى إلى الحسين
في التراث السني، يحتل عاشوراء مكانة دينية ترتبط بحدث قديم عظيم، وهو نجاة النبي موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون. ولما قدم النبي محمد ﷺ المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فأقرّه وأوصى به، وقال:
“نحن أحق بموسى منهم”، وأمر بصيامه، ليصبح صيام عاشوراء سُنّة نبوية مؤكدة، يُرجى بها تكفير ذنوب سنة كاملة.
أما في التراث الشيعي، فإن القداسة تتجاوز الحدث التاريخي إلى المأساة الكبرى، ففي هذا اليوم عام 61 هـ، استُشهد الإمام الحسين بن علي، حفيد رسول الله ﷺ، مع أهل بيته وأصحابه في واقعة كربلاء. ومنذ ذلك الحين، غدا عاشوراء رمزًا للثورة على الظلم والانحراف، وعنوانًا للبطولة والفداء.
طقوس مختلفة لليوم نفسه
يرى السنة في عاشوراء يوم صيام وتوبة وشكر لله على نصره لعباده الصالحين، ويُستحب أن يُصام معه يوم تاسوعاء (9 محرم) مخالفة لليهود. ولا تقام فيه طقوس حداد أو مظاهر حزن، بل يُعد من الأيام الفاضلة التي يُبتغى فيها الأجر.
أما عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، فالأمر مختلف تمامًا. حيث يُعد عاشوراء يوم الحزن الأكبر في التقويم الشيعي. وتُقام فيه مجالس العزاء والخطب الدينية، وتُنظم مواكب اللطم والبكاء والتطبير، تعبيرًا عن الحزن على الإمام الحسين وأهل بيته، وتأكيدًا على الولاء لخط كربلاء ونهج المقاومة.
عاشوراء: رمز الصراع بين الحق والباطل
يُرفع في الثقافة الشيعية شعارٌ يتجاوز اللحظة التاريخية:
“كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء”.
وهذا يعكس تصورًا لعاشوراء كـ رمز دائم للثورة على الظلم والفساد، وليس مجرد ذكرى لمأساة تاريخية. ولذلك، يُستحضر الحسين في كل مناسبة تتطلب الصمود والتضحية، من العراق إلى لبنان، ومن إيران إلى أفغانستان.
أما في الثقافة السنية، فرغم الاعتراف بفضل الإمام الحسين ومكانته، إلا أن الحدث لا يُؤخذ بطابع طقوسي سنوي، ولا يُمارس الحزن العلني أو المظاهر الجماعية للحداد. ويؤكد علماء أهل السنة على أن استشهاد الحسين مصيبة عظيمة، لكنها تُقابل بالصبر والاحتساب، لا بإحياء مظاهر لم ترد في السنة النبوية.
بين الاتفاق والخلاف
يُجمع المسلمون، شيعة وسنة، على مكانة الإمام الحسين، وأنه سيد شباب أهل الجنة، وحفيد رسول الله ﷺ. كما يتفق الجميع على بشاعة ما جرى في كربلاء، وإن اختلفوا في الفاعل، والقراءة السياسية، والسبل التعبيرية عن هذه الذكرى.
الاختلاف في عاشوراء لا يتوقف عند الطقوس، بل يمتد إلى الرؤية التاريخية والموقف من الدولة الأموية، وما تمثله من رمزية لدى كل طرف.
ختامًا: عاشوراء مرآة للاختلاف المشروع
عاشوراء، بما يحمله من معانٍ روحية وسياسية وتاريخية، يفتح الباب للتأمل في طبيعة الاختلاف داخل الأمة الإسلامية. اختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى صراع، بل يمكن أن يكون فرصة لفهم الآخر، وتقدير تعددية الذاكرة الدينية، ما دام الاحترام والتعقل هما القاعدة.
وربما كانت أعظم دروس عاشوراء، أن الحق لا يُعرف بالغلبة، بل بالموقف والمبدأ، وأن وحدة الأمة تمر عبر الاعتراف باختلافاتها، لا محوها.
حميدو صقر